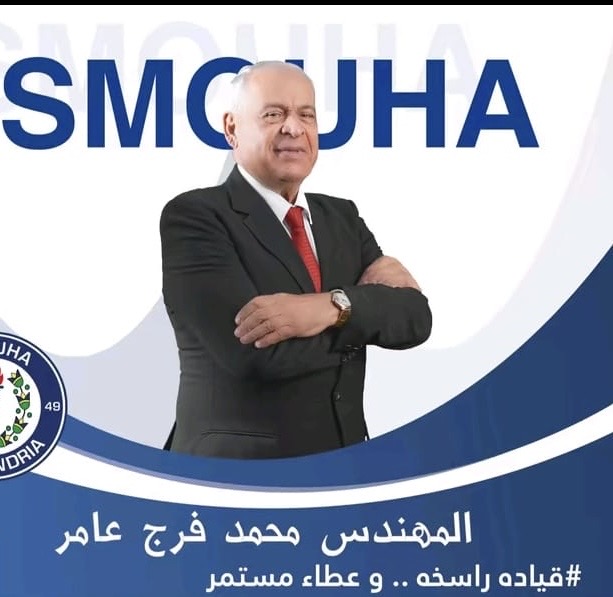قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!

اعتدنا أن نشعر بالطمأنينة حين نلتقي بمن يشبهنا، فنقول ممتنين “دي ناس شبهنا”!
كلمات تكررت كثيرا في السياق المجتمعي المعاصر للتعبير عن الشعور بالارتياح عندما يصادفنا شخص يشبهنا، فيكون تلقائيا وفقا لمعايرنا واحكامنا “صالح” ان يكون في المعية والصحبة، وبطبيعة المنطق البشري، من كان مختلفا أي مناقضا لما نعتنقه من قناعات و عن ما نعيشه من منهج حياة، فلن يكون القبول احتمالا واردا!
والغريب في هذا الامر، ان هذه الكلمات قد تحولت مع مرور الوقت لاكليشيه، يتصدر الأحاديث الجانبية في مقاهي القاهرة المزدحمة وتلك المتشبهة بمطاعم الغرب وايضا الملتقيات العائلية وطاولات المصايف الفارهة وحتي في السجالات الشعبية لراكبي المواصلات العامة، بينما نجد علي صعيد موازي، كبار الساسة واباطرة النخب الثقافية المؤمنون بحوار الحضارات يتكلمون بلغة رصينة عن “قبول الاخر”!
ومن هنا استشعرت ضرورة الوقوف امام هذا التناقض الواضح بين اكليشيه ” دي ناس شبهنا ” الذي يعني بشكل غير مباشر، رفض الاختلاف وشعار “قبول الآخر/الاختلاف” الذي يتردد بكثافة، واخذتني الشجاعة لاقتناص شرف محاولة الرد علي السؤال الحائر:
هل مصطلح “قبول الآخر” مازال يحمل في طياته شغف معرفة الآخر مهما كان مختلفا؟ وهل مازال يعني المودة وكرم القلب والفكر ووعي الادراك؟ ام أصبح أحد أحاديث الجوي؟
عزيزي القارئ
اسمعك تهمهم وتقول الا تري ما يحدث حول العالم من الكيل بمكيالين؟
كيف للإنسان المظلوم ان يقبل الاخر؟
نعم.. فان العالم اليوم يقف امام مشاهد متناقضة، تكشف صعوبة التعايش وتعقد فكرة قبول الآخر.
في الحقيقة، فان الزمن الذي نخوضه هو زمن الرهانات السياسة التي تحكم وتتحكم في عالم اهوج يأخذنا كل يوم الي حافة اللامعقول، ويغرقنا في فوهة أحداث غير منطقية ويغتال سلامنا بنيران قضايا متشابكة.
تابعنا جميعا المظاهرات الشعبية الكبيرة في قلب أوروبا سواء كانت في العاصمة البريطانية لندن أو العاصمة الفرنسية باريس وهي تندد وتشجب تهاون حكامهم في فتح الحدود أمام ما يعرفه بالهجرة غير الشرعية ويتهموهم بعدم اتخاذ قرارات لردع هؤلاء وعدم تعظيم أحكام القوانين الداخلية للبلاد وفقا للأعراف والقوانين المعمول بها منذ نشأة هذه البلاد لطرد المهاجرين لرفضهم التعايش مع هؤلاء البشر.
وفي مشهد آخر نرى في نيوزيلندا وأيضا في أستراليا مظاهرة شعبية حاشدة تنتقد فيها صمت العالم أجمع أمام ما يحدث في غزة من ترهيب وتخويف وتجويع لأطفال غزة.
وفي مشهد ثالث لا يخفي علي احد، هو تلك التقارب الصيني الإفريقي، الالمع علي أرض الواقع والذي من المتوقع براجماتيا ان ياتي بثماره في السنوات القادمة في ظل توازن جديد للقوي العظمي علي الخريطة الدولية.
اليوم، توزع أمام أعيننا مشاهد متناقضة: من جهة، صراع دامٍ ورفض للآخر، ومن جهة أخرى، مؤتمرات ومبادرات تدعو إلى “التعايش السلمي” والتعددية الثقافية.
ماذا نقرا من هذه المشاهد السياسية المتناقضة علي الخريطة الدولية؟
الامر واضح، تبدو هذه المشاهد المختلفة وكأنها تكشف جليا أن السياسة ليست إلا انعكاسًا لما غُرس في النفوس منذ الطفولة، وأن الثقافة هي الجسر أو الجدار الذي يحدد شكل العلاقة مع الآخر.
ولكي نعمّق هذا الطرح، لا بد من استدعاء التاريخ، فصفحات الماضي، القريب والبعيد، مليئة بأمثلة تصلح أن تكون حجر الزاوية لفهم كيف تعاملت الأمم مع “الآخر”. ففي كل مرة أرادت السياسة أن تؤسس لنظام جديد، كان قبول الآخر أو رفضه هو العامل الحاسم في نجاح ذلك المشروع أو سقوطه.
ففي بدايات القرن العشرين، استقبلت الولايات المتحدة ملايين المهاجرين من أوروبا الشرقية والجنوبية. ورغم أن عملية الاندماج لم تكن سهلة، فإن فلسفة “الحلم الأمريكي” التي جرى ترسيخها عبر التعليم والإعلام ساعدت على تحويل التنوع إلى قوة دفع حضارية، بدلاً من اعتباره تهديدًا. هذه التجربة تؤكد أن الثقافة الرسمية قادرة على صياغة نموذج ناجح للتعايش.
وفي مثال آخر، نجد أن ألمانيا بعد انهيار النازية أعادت بناء نظامها التعليمي على أسس جديدة ترفض العنصرية والتعصب. هذه المقاربة التربوية أثمرت أجيالًا أكثر انفتاحًا على قيم الديمقراطية والتعددية، رغم وجود تيارات متطرفة تظهر بين الحين والآخر.
أما جنوب إفريقيا، فقد شكّلت تجربة فريدة بفضل سياسة “المصالحة الوطنية” التي قادها نيلسون مانديلا. فقد تحوّل مجتمع كان قائمًا على الفصل العنصري الصارم إلى نموذج عالمي في قبول الآخر والتعايش بين مختلف الأعراق. ولم يكن ذلك مجرد تحول سياسي، بل تأسس على خطاب ثقافي وتعليمي زرع قيم التسامح والاعتراف بالآخر
وفي العصر الحديث نجد نماذج أخرى بارزة، فكندا علي سبيل المثال، تبنّت سياسة التعددية الثقافية وجعلت منها ركيزة للنمو وجزءًا من هويتها الوطنية، بينما خاض الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في دمج ثقافات واقتصادات متباينة بعد توسعاته، ورغم الصعوبات أثبت أن الحوار والقيم المشتركة يمكن أن تكون أساسًا للتقارب. وفي رواندا، وبعد الإبادة الجماعية، جرى استخدام التعليم والخطاب الثقافي كأداة لترميم المجتمع المنقسم وإعادة بنائه على أسس جديدة من التعايش. أما الإمارات العربية المتحدة فقد قدمت نموذجًا فريدًا في إدارة التنوع عبر احتضانها جاليات من أكثر من مئتي جنسية تعيش وتعمل في فضاء واحد.
كل هذه التجارب التاريخية والمعاصرة تثبت أن قبول الآخر ليس شعارًا سياسيًا يرفع عند الحاجة، بل هو ثمرة عملية طويلة تبدأ من البيت وتترسخ في المدرسة وتُبنى على أساس دور المرأة والمجتمع في التربية والثقافة. والتناقضات التي نراها اليوم بين رفض المهاجر في أوروبا ومساندة الفلسطيني في أستراليا وتقارب الصين مع إفريقيا توضح أن السياسة ما هي إلا انعكاس لما غُرس في العقول والقلوب منذ الصغر. وحين تكون الثقافة جسرًا تصبح السياسة أكثر إنسانية، أما حين تتحول إلى جدار فإنها تنقلب إلى صراع دائم مع الآخر!